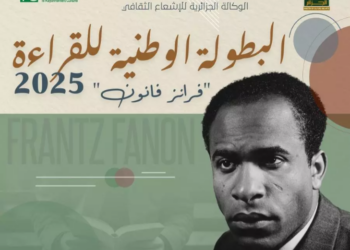النقد الأدبي هو أحد التخصّصات التي تحلّل وتقيّم الجوانب المختلفة للأعمال الأدبية.. ويحاول النقّاد الكشف عن خفايا النصّ وتقييم الجدارة الفنية للعمل، بتفسير الموضوعات والشخصيات والرموز والأسلوب الذي يستخدمه المؤلّف. ولم تتوقّف حركة النّقد بالجزائر عند تيار أو مدرسة أو منهج نقدي بعينه، بل انتقلت في كلّ الاتجاهات، ما قد يؤشر على مواكبة فعلية للمثقّف الجزائري لما يدور حوله.
ملف: أسامة إفراح وإيمان كافي وفاطمة الوحش ورابح سلطاني وأمينة جابالله ومحمد الصالح بن حود
النّقد الأدبي بالجزائر.. عقود من التأصيل والتطوّر
يعمل النّقد الأدبي على تقديم رؤى حول تعقيدات العمل الأدبي، وكشف الفروق الدقيقة التي قد لا تكون واضحة للقارئ العادي، ويعمّق بذلك فهمنا وتقديرنا للأدب.
 ويقول يوسف بن نافلة (جامعة الشلف) إنّه إذا كان النّقد الأكاديمي يميل إلى تفسير النصّ الأدبي بخارجه، أيّ بالظروف المحيطة به، اجتماعية، أو نفسية، أو تاريخية، فقد سمي النّقد الذي مارسه “رولان بارت” ورفاقه بـ«النّقد الجديد”، وأعاد الاعتبار للنصّ الأدبي بالقبض على معناه، واكتشاف بنيته، وسرّه، وكنهه، وجوهره، وهذا يتحقّق بتقاطع اللّسانيات، والبنيوية، والسيميولوجيا، والتحليل النفسي، فتتعايش كلّ هذه المجالات المعرفية داخل عملية التأويل.
ويقول يوسف بن نافلة (جامعة الشلف) إنّه إذا كان النّقد الأكاديمي يميل إلى تفسير النصّ الأدبي بخارجه، أيّ بالظروف المحيطة به، اجتماعية، أو نفسية، أو تاريخية، فقد سمي النّقد الذي مارسه “رولان بارت” ورفاقه بـ«النّقد الجديد”، وأعاد الاعتبار للنصّ الأدبي بالقبض على معناه، واكتشاف بنيته، وسرّه، وكنهه، وجوهره، وهذا يتحقّق بتقاطع اللّسانيات، والبنيوية، والسيميولوجيا، والتحليل النفسي، فتتعايش كلّ هذه المجالات المعرفية داخل عملية التأويل.
تطوّر النقد الأدبي بالجزائر
يعتبر صالح جديد (جامعة الطارف) أنّ حركة النّقد في الجزائر لم تتوقّف في مرحلة ما عند تيار أو مدرسة أو منهج نقدي بعينه، بل انتقلت في كلّ الاتجاهات، وهذا التنقّل وتلك الحركية يؤكّدان حقيقة المواكبة الفعلية للمثقّف الجزائري لما يدور حوله، سواء في العالم العربي أو الغربي، من تجاذبات في عالمي الأدب والنّقد.
ويلخّص الباحث تطوّر النّقد الأدبي الجزائري في عدد من المحطات الرئيسية:
أولا، في مرحلته التقليدية من الاحتلال إلى الاستقلال، لم يخرج النّقد عن القضايا التي اهتم بها النقاد العرب القدامى (اللّغة والبلاغة والمضامين في مفاهيمها التقليدية)، وذلك بحكم المرحلة (الاحتلال وحداثة عهد الاستقلال).
ثانيا، برز النّقد الجزائري في المرحلة التقليدية بصورة واضحة في المقالات النّقدية التي ظهرت في صفحات الجرائد والمجلات الجزائرية والعربية، واحتشام انتشار الكتب المطبوعة لأسباب مالية وفنية كنقص دور النشر والمطابع، زد على ذلك نقص وعي المثقفين في تلك المرحلة بالدور الفعّال للنّقد من منطلقات الأدب الجزائري، والتركيز على الأدب العربي قديمه وحديثه. غير أنّ الصحافة الثقافية كانت نشطة وبفضلها برزت الأسماء التي تعلو تاج النّقد الجزائري.
ثالثا، غلب التوجّه التربوي والتأريخي للنصوص النّقدية على الأبعاد الجمالية والفنية، ويمكن أن نعد نقد هذه المرحلة بالنّقد “الشمولي الهاوي”، عدا أعمال كان أصحابها من أهل الاختصاص أو الأكاديميين.
رابعا، انتقل النّقد في مرحلة الستينيات والسبعينيات إلى النقد المنهجي؛ أيّ القائم على تتبع ظاهرة نقدية سواء بالتنظير أو التطبيق وفق المقولات النّقدية الغربية، وهذه الممارسات ظهرت مع النقّاد الأكاديميين، فأغلب ما ظهر منها هو في حقيقته رسائل جامعية معدّة لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه ثم قام أصحابها بطباعتها ونشرها، وتم ذلك في الغالب على حساب مؤسّسات الدولة الجزائرية.
خامسا، غلبت موجة النّقد الماركسي والبنيوي على نقد هذه المرحلة إلى غاية تسعينيات القرن الماضي، حيث سجّلنا تراجع العمل النّقدي القائم على الأيديولوجيا إلى النّقد القائم على العلمية، وبخاصّة ما ارتبط منه باللّسانيات بكلّ أنواعها.
سادسا، ظهر جيل من النقّاد الجزائريين الشباب الساعين للتحكّم في فلسفات المدارس النقدية ومناهجها، وبخاصة الغربية منها، ومحاولة استثمارها في النص والنقد الجزائري.
وفي دراستها للنّقد الأدبي الجزائري الحديث، نوّهت صباح لخضاري (المركز الجامعي النعامة) بجهود رواد النّقد في الجزائر الذين بحثوا عن منهج نقدي جزائري، وكان هذا النّقد متشبّعا بالعديد من المشارب النّقدية العربية والغربية، خاصّة منها النّقد الاجتماعي لأنّه كان يساير الأوضاع السياسية الوطنية والعالمية في تلك الآونة.
وبعد ما أسماه مصايف “النقد التأثري” الذي عرفته الجزائر، وهو النّقد الذي واكب تطوّر النّقد العربي عموما، والتجديد في الإبداع العربي نتاج التأثر بالتيارات الأدبية والنّقدية الغربية (التي جعلت الذّات الإنسانية قطب اهتمامها)، التفّ جلّ الأدباء والمهتمين بالدراسات الأدبية بالمنهج الاجتماعي أو المنهج الواقعي الذي تفرّع أنصاره إلى منهج الواقعية القومية ومنهج الواقعية الاشتراكية، وتقول الباحثة إنّ سبب هذا الالتفاف، الظروف الاجتماعية والسياسية في الجزائر، إذ كان هذا المنهج أقرب للمبدع في التعبير عن هموم وطنه وشعبه الذي يعاني من نير الاستعمار، ليزداد ترسّخه في الجزائر بعد الاستقلال لتأثير الإيديولوجيا السائدة آنذاك، لتصبح وظيفة الأدب وظيفة اجتماعية، لكن مع عدم نسيان الذات، إذ هي في علاقة جدلية مع الواقع والمجتمع وهي التي تعبّر عنه بتآلفها مع الذوات الأخرى داخله.
ونتج عن هذا ما سمي بـ«أدب الالتزام” الذي كانت الحرية – هو الآخر – شريعته وديدنه، وهي الحرية التي يعتبرها الكيبي “ضرورية للأديب”، مضيفا أنّ “الفنان الصادق هو الذي ينطلق في التعبير من أصالة فكره واقتناعاته”.
إشكالية المنهج
يشير كلّ من محمد رندي وعلي ملاحي (جامعة الجزائر2) إلى ريادة عبد الله الركيبي في تطبيق المنهج التاريخي في النقد الجزائري، من خلال مؤلّفات له على غرار “تطوّر النثر الجزائري الحديث”، و«الشعر الديني الجزائري الحديث”، وبالأخصّ “القصّة الجزائرية القصيرة”. كما يعتبر محمد مصايف علامة فارقة في النّقد الأدبي السياقي الجزائري، فهو “شيخ النقّاد الذي تتلمذ على يده كثيرون (…) رغم امتناعه عن حقيقة المنهج الذي يتوسّله، وهو المنهج الاجتماعي”، وهو ما تجلّى في أعماله، خاصّة “دراسات في النّقد والأدب” و«النثر الجزائري الحديث”. وهو المنهج الذي وظّفه بعده عمار بلحسن، ومحمد بوشحيط، وواسيني الأعرج، ومخلوف عامر. أما أحمد حيدوش، فقد امتاز بتوظيف المنهج النفسي، وتبعه عبد القادر فيدوح وزين الدين المختاري وغيرهما.
بالمقابل، لاحظت صباح لخضاري أنّ هاجس التأصيل لنقد جزائري عربي بدأ يظهر في الجزائر مع عبد الملك مرتاض منذ الثمانينيات، بعد أن حاول هضم التراث العربي والاطّلاع على النّقد الغربي، وعبد الملك مرتاض من جيل النقّاد الأوائل، عمل جاهدا على إسماع صوته، وإحراز مكانة مرموقة بين النقّاد العرب مشرقا ومغربا. وهو يتميّز أيضا بمنهج شمولي، إذ لا يؤمن بمنهج واحد في الدراسة النّقدية، بل يعتمد منهجا تركيبيا مفتوحا على مجموعة من المناهج التي يراها فعّالة في استنطاق النصّ وتفكيكه، لذلك نجده يجمع بين الآليات النّقدية العربية القديمة والإجراءات الغربية الحديثة، حتى اتّهم باللامنهج، مع العلم أنّه على دراية تامّة بهذا المزج والتركيب بين المناهج في أعماله النّقدية، فقد تبنّى إستراتيجية اللاّمنهج ودعا إليها منذ إصدار كتابه “النصّ الأدبي من أين؟ وإلى أين؟” عام 1983، وأدّى به المزج بين المناهج إلى تبنّي استراتيجية القراءة بدل اعتماد مصطلح النّقد، فهو يعدّ نفسه مجرد قارئ محترف، لذلك كان النّقد عنده مجرد قراءة شخص محترف لنصّ أدبي ما، والأدوات التي يصطنعها في فهم النصّ أو قراءته أيّ تأويله هي التي تحدّد معالم التحليل الذي ينشأ عـن مسعاه الأدبي. وتبقى الآليات النقدية عند عبد الملك مرتاض، كيفما كانت فاعليتها في استنطاق النصّ، مجرد وسيلة لفهم النصّ وتذوّقه وليست غاية في حدّ ذاتها.
وخلصت لخضاري إلى أنّ الإيمان بشمولية المنهج النّقدي، والاحتراز من استخدام منهج معين في الدراسة الأدبية، وعدم تحديد المقاييس النّقدية وتركها مفتوحة، والمزج والتركيب بين العديد من المناهج قديمها وحديثها، من خصوصية الناقد الجزائري “الذي يمقت حبس نفسه في سياج منهج معين، بل يترك نفسه حرّا طليقا لممارسة العملية النّقدية”.
وأضافت أنّ السمة الغالبة على النّقد الجزائري عدم التمكّن من تحديد منهج معين لنقّاده، لأنّ أغلبهم يؤمن بحرية النّاقد في الممارسة النقدية التي يركب فيها بين العديد من المناهج، إلا أنّه لا يمكن تجاوز ذكر بعض المحاولات النّقدية التي عملت على تطبيق صرامة منهج معين في دراستها مثل أعمال بورايو ورشيد بن مالك التي طبّقت المنهج السيميائي.
التأسيس لدرسة نقديـة جزائرية
ينقل عتاوية بن عطوش (جامعة سيدي بلعباس) رأي مخلوف عامر القائل بأنّ الزخم التراكمي في الإنتاج الأدبي يقابله تخلّف في الحركة النّقدية، وسبب هذه المفارقة يرجع إلى الحركة البطيئة للنّقد، وعزوف الذين يدرسون الأدب عن النّقد مفضّلين الكتابة الإبداعية شعرا أو نثرا، والحظ الأوفر كان للرواية، ويضيف أنّ التجربة النّقدية في الجزائر تبقى بحاجة إلى تطوير رغم وجود بعض النقّاد أمثال المرحومين محمد مصايف وعبد الله ركيبي اللذيْن واكبت تجربتهما فترة معيّنة، مشيرا إلى وجود أعمال أدبية روائية واكبت الإنتاج العربي والعالمي بحاجة إلى أقلام نقدية تخدم الحركة الإبداعية الروائية بالجزائر، وأثنى على جهود بعض الأقلام المميّزة من أمثال السعيد بوطاجين وآمنة بلعلى..
كما يستأنس بن عطوش بما قال حبيب مونسي، حين اعتبر أنّ الدرس النّقدي لم يؤثر في الرواية، ولم يصنع فيها توجيهات وتيارات، ولا هو غيّر من أفق المبدعين من خلال التقييم والتقويم.. لأنّ الملاحظ اليوم هو استمرار المبدع في مضماره يسير أماما لا يلوي على شيء وقد سدّ أذنيه أمام الأصوات الباهتة التي تأتيه من اجتماعات المقاهي والجلسات الخاصّة. واستمرّ الدارس ـــ هو الآخر ـــ خاضعا لصنمية منهج لا يعرف عنه إلا بعض تجلّياته الأدبية بجريه هنا وهناك بنفس الطريقة، فيكرّر نفسه في كلّ محاولة حتى غدت كثير من الدراسات تتشابه في عناصرها ولغتها وخططها.
ويؤكّد مونسي أنّ “النّقد الذي لا يقتل ولا يحيي هو النّقد البارد الفاتر.. هو ذاك الواصف الذي يتدجّج بمناهج واصفة أفرزتها الحداثة الغربية. هذا النّقد يركن إلى الوصف المحايد الذي يعجز عن التفرقة بين نصين من حيث القيمة الجمالية والفكرية، وغدت كلّ النصوص صالحة لأن تكون موضوعا للدراسة.. فالمناهج الواصفة لا أمام أصحابها فرص التدبّر الفكري في المسائل المطروحة.. ولا يهمها ما يقوله النصّ.. ولماذا يقوله؟ وإنّما المهم عندها هو الكيفيات التي يقول بها النصّ أشياءه.. ومن ثمّ فليس المهم جديد الفكرة أو فرادتها، أو تميّزها وإنّما المهم أن تكون قولا قيل بكيفية معيّنة، لأنّ الدارس لا يجرأ على أن يصدر في شأنها حكما أو أن يبدي فيها رأيا”.
وخلص بن عطوش إلى أنّ المشكلة تكمن في عدم قدرة الباحث على مناقشة الأفكار، ولكن الأدب يبشّر بالخير ما دامت الساحة النّقدية تعجّ بقراءات وتحليلات للنصوص الإبداعية باختلاف أجناسها، وخاصّة في مجال الرواية التي تشهد تراكما كميا وكيفيا في الساحة الأدبية.
من جهته، لاحظ صالح جديد أنّه رغم وجود العديد من دور النشر والطباعة، إلا أنّ كثيرا من الأعمال النّقدية الجادة والأكاديمية لم تر النور بعد، ومازالت حبيسة رفوف المكتبات الجامعية. كما لاحظ انحسار الاهتمام الإعلامي بحركة النّقد، إلى جانب “غياب رؤية واضحة من قبل نقّادنا للتكتّل في مؤسّسة رسمية تجمع شملهم وتوحّد كلمتهم”، و«انغلاق حركة النّقد على النخب والأكاديميين والجامعيين وعدم القدرة على الانفتاح على المتلقين بمختلف ثقافاتهم ومؤسّساتهم”.
الدكتور عبد الحميد هيمة: من يواكب من؟ النّاقد أم المبدع؟
 يرى الأستاذ بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، الدكتور عبد الحميد هيمة، أنّ النّقد الأدبي بالجزائر بدأ بالنّقد السياقي منذ مطلع السبعينيات، وقد كان نقدا أكاديميا وليد المؤسّسة الجامعية، ثم حدث التطوّر نحو المناهج النسقية (النصّية)، في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات مع عبد الحميد بورايو، وعبد المالك مرتاض وغيرهم.. ممّن انتصروا للنّقد الشكلاني، ممثلا في تيارات البنيوية والتفكيك الّتي سعت إلى تحويل النّقد إلى نوع من العلم الإنساني الجديد، وكانت كلمة النظام هي الأيقونة أو الطقس الرمزي الذي يتعبّد له النقّاد الذين أرادوا إضفاء طابع علمي على الممارسة النّقدية..
يرى الأستاذ بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، الدكتور عبد الحميد هيمة، أنّ النّقد الأدبي بالجزائر بدأ بالنّقد السياقي منذ مطلع السبعينيات، وقد كان نقدا أكاديميا وليد المؤسّسة الجامعية، ثم حدث التطوّر نحو المناهج النسقية (النصّية)، في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات مع عبد الحميد بورايو، وعبد المالك مرتاض وغيرهم.. ممّن انتصروا للنّقد الشكلاني، ممثلا في تيارات البنيوية والتفكيك الّتي سعت إلى تحويل النّقد إلى نوع من العلم الإنساني الجديد، وكانت كلمة النظام هي الأيقونة أو الطقس الرمزي الذي يتعبّد له النقّاد الذين أرادوا إضفاء طابع علمي على الممارسة النّقدية..
يقول عبد الحميد هيمة: “لقد رغب النّقد الحديث في القرن العشرين أن يكون جزءا من حقل المعرفة العلمية التي تستند إلى التجريب والاختبار، لكنّه في طريقه لعلمنة الحقل النّقدي أطاح بالجانب الشخصي والفردي في تذوّق الأدب، كما ساهم أيضا في تحويل هذا الحقل إلى جزيرة نخبوية لا يسعى إلى الإبحار نحوها سوى المتخصّصون.”
وأكّد المختصّ في الأدب والنّقد العربي الحديث والمعاصر لـ«الشعب” أنّ في هذه اللحظات المفصلية من عمر النّقد الأدبي، جرى التمهيد لـ«موت النّاقد” وانسحابه من المشهد واكتفائه بالعمل داخل أسوار مؤسّسته الأكاديمية، ولكنّ المشكلة هي أنّ النّاقد الأكاديمي لم ينسحب من المشهد وحده، بل إنّه أطفأ نور القاعة بعد انسحابه، ممّا أدّى إلى القطيعة بين النّقد المتخصّص والقارئ العام المتعطّش إلى معرفة رأي النقّاد في النصوص، ممّا فسح المجال للنّقد الصحفي غير المتخصّص، ولنقّاد الصحف غير المتخصّصين لتوجيه ذائقة القراء أكثر من النقّاد المتخصّصين، الأمر أدّى إلى موت النّاقد بالمعنى المجازي – حسب المتحدّث – ليترك مكانه للقارئ غير المتخصّص الذي يستطيع أن يدلي بدلوه في ضوء تطوّر وسائل الاتصال، وأن يضفي قيمة على الأعمال الإبداعية التي يقرأها دون حاجة إلى ناقد متخصّص يرشده ويدلّه على النصوص التي يجب قراءتها، إذ نسجّل بكلّ أسف – يقول هيمة – تقهقر النّقد المتخصّص والنّاقد المتخصّص الذي لم يعد يطلّ على القراء في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة.
ويرى هيمة أنّ ضعف دور النّاقد في الوقت الراهن يرجع إلى انتشار المدوّنات والمواقع في شبكة الانترنت التي تتيح لأيّ شخص أن يبدي رأيه فيما ينشر من أعمال روائية، وهذه الكتابات أصبحت توفر الرأي النّقدي المطلوب للقارئ العام، الذي يريد أن يجد من يوجّهه إلى الأعمال الأدبية الجيّدة، وقال: “نحسب أنّ النّقد المتخصّص سوف لن تبقى له المكانة السابقة، وقد تسارع اليوم حضور هذا النوع من النّقد بعد التطوّر الذي حدث على الشبكة العنكبوتية، التي وفرت منصّة سهلة للقراء لإبداء الرأي في النصوص الأدبية بكلّ ديمقراطية”.
وهذا يؤشّر على تآكل سلطة النّقد المتخصّص، وبروز هذا النّقد غير المتخصّص الذي قد يسئ للمشهد الأدبي كما ذكر البروفيسور هيمة، مشيرا إلى أنّ السبب في ذلك يعود إلى أنّ هؤلاء الكتّاب والنشطاء على الشبكة العنكبوتية، لا يتمتّعون بحسّ المسؤولية والمعرفة بالمقارنة بالنّقد المتخصّص، وهو ما يجعل القارئ فريسة في يد جهات احتكارية تعمل على توجيهه نحو خيارات غايتها الأساس هي الربح من بيع الكتب والأعمال الإبداعية، والنتيجة أنّنا سنصبح أسرى للضجيج “التواصلي”.
وقال محدّثنا: “إذا عدنا إلى مسألة راهن النّقد الروائي، والعلاقة بين هذا النّقد والأدب نلحظ كما سبق الذكر سيطرة النّقد الشكلاني الذي يُعلي من شأن النصوص الروائية الأكثر توظيفا للتقنيات السردية الجديدة ولأشكال جمالية أخرى، كالتناصات بكلّ أنواعها، والتحاور مع الفنون، وتعدّد الأصوات وغيرها، بناءً على النظريات البنيوية والسيميائيات وغيرها.
ويضيف: إنّ هذا الأمر جعل من المبدع الجزائري يسابق إلى العناية بالشكل على حساب المضمون، وصار الروائي يتبع النّقد ويقوم بمغازلة أحدث نظرياته لكي يفوز بالاهتمام النّقدي السائد. ومع هذا النوع من النّقد صرنا نتساءل: من يواكب من؟ هل النّقد يواكب الإبداع؟ أم الإبداع يواكب النّقد؟
البروفيسور علي ملاحي: النقد اختبار معرفي وليس ممارسة وصاية
 يرى الدكتور علي ملاحي أنّ النّقد الأدبي لا يعني الدخول في عملية مصادرة أو تسويق أفكار بطريقة قسرية على النصّ والكاتب، وأشار إلى أنّ النّقد يكون مقبولا حين يتجنّب الناقد التحامل والتجاوز والتطاول؛ لهذا اتّجهت الدراسات النّقدية المعاصرة إلى سلوك معرفي يفرض على النّاقد اعتماد فكرة الاختبار بدل ممارسة الوصاية.
يرى الدكتور علي ملاحي أنّ النّقد الأدبي لا يعني الدخول في عملية مصادرة أو تسويق أفكار بطريقة قسرية على النصّ والكاتب، وأشار إلى أنّ النّقد يكون مقبولا حين يتجنّب الناقد التحامل والتجاوز والتطاول؛ لهذا اتّجهت الدراسات النّقدية المعاصرة إلى سلوك معرفي يفرض على النّاقد اعتماد فكرة الاختبار بدل ممارسة الوصاية.
وقال ملاحي لـ«الشعب” إنّ عملية التحليل والتأويل تتحقّق حين يتعامل النّاقد مع النصّ بوصفه وثيقة عمل قابلة للأخذ والردّ.. ولذلك لا يوجد النصّ المنزّه الفوقي والسفلي، فالنصوص كلّها تخضع لاعتبارات منهجية واحدة، طالما أنّ النصّ خرج إلى العلن ودخل في عملية تواصل مع المتلقّي”.
بخصوص واقع الحركة النّقدية بالجزائر، يرى ملاحي أنّنا نعيش حالة ارتباك ثقافي غير مؤسّس على ضوابط، موضّحا أنّ النّقد “تحوّل إلى فلسفة تغليب العلاقات الشخصية على التحليل المعرفي، وصارت عمليات المصادرة تطبّق جهارا، لدرجة أنّ بعض الأدباء لا يتقبّلون أن تتعامل مع النصّ بما فيه، وما يهمّهم هو أن تزكّيه بأيّ شكل من الأشكال، حتى ولو كان هذا النصّ ركيكا أو مبتذلا”.
وتأسّف ملاحي لكون النصوص المتداولة – في كثير من الأحوال – فقيرة أدبيا وتسيء لسمعة الإبداع بالجزائر نتيجة طغيان الكتابات الهشّة في مختلف الأجناس الأدبية، ولفت إلى أنّ النقد الأدبي بالجزائر أفلت الإحكام المعرفي، إلى درجة أنّ بعض الهيئات الثقافية والجامعية تسوّق للركاكة خارج الوطن دون أيّ وازع أو إحساس بالمسؤولية، ويجدون من يروّج لهم سلعتهم، ويحفّزهم على التمادي في الغيّ الثقافي الذي يسيء إلى الوجه الحضاري لوطن له تاريخه التحرّري والتاريخي الكبير، لهذا السبب وجد النقّاد الكبار أنفسهم أمام كومة من الكتابات المضلّلة التي تمسّ بمصداقيتهم” يقول ملاحي.
ويؤكّد محدّثنا أنّ الحاجة ماسّة إلى “حماية الأسماء النّقدية الكفؤة التي لها دراية معرفية وخبرة بالنصوص وبالتجارب الأدبية، من أمثال الراحل الكبير عبدالملك مرتاض وعبدالله الركيبي وأبوالقاسم سعدالله ومحمد مصايف ورمضان حمود، وشريبط أحمد شريبط ومحمد بوشحيط وبختي بن عودة”.
ويضيف: “هذا الموقف يحيلنا إلى أن نتعامل إعلاميا وإداريا ووظيفيا وثقافيا مع الأسماء النّقدية الجديدة، أمثال النّاقد سعيد بوطاجين وعبد القادر فيدوح ويوسف وغليسي ومحمد داود واليامين بن تومي وعبدالغني بارة وأمينة بلعلى وعبدالحميد بورايو ومحمد ساري وأمين بحري والطيب صياد.. وغيرهم من الأسماء الفاعلة في حقل الكتابة النّقدية التي تتطلّب من الدارسين التأسيس والتوثيق والاعتراف بوجودها، وهم كلّهم في مجموعهم دون استثناء يمثلون قلّة قليلة في الفضاء النّقدي العربي، بالمقارنة مع ما تشهده التجربة النّقدية في مصر، تونس، قطر، سوريا، العراق، اليمن، البحرين وفي موريتانيا وليبيا ..
وفي السياق ذاته، أشار المتحدّث إلى أنّه لا يجب أن نتغافل في بلادنا عن نقّاد كبار قدّموا أطروحات أكاديمية في مختلف الجامعات الجزائرية، ولم تتح لهم الفرصة لنشر أعمالهم الفعّالة علميا وثقافيا، وقال: “كلّ هذه الأسماء وغيرها تمثل بالنسبة لنا أسماء مميّزة تساهم في صنع الفعل النّقدي وحركيته وسيرورته في الجزائر.”
ومن جهة أخرى، أكّد البروفيسور علي ملاحي أنّ المؤهّل نقديا هو صاحب الملكة النّقدية المنصهرة مع الملكة الأدبية، وقال: “النّقد وجدان ومعرفة وخبرة بالنصوص وتجربة واعية وليس مجرد ممارسة تجريبية ..الممارسة النّقدية تحتاج إلى كفاءة وحسّ نقدي وتجربة وانصهار مع التجارب النظرية النّقدية، ناهيك عمّا يحتاج النّقد من قدرات على التأمّل وشجاعة في المعالجة والطرح، وسعة الأفق النّقدي والمعرفة بأصول الخطاب الأدبي”، وأضاف: “نحن لا نستطيع أن نصادر اسما نقديا مثل رشيد بن مالك مثلا، خاصّة عندما يتعلّق الأمر بالنسبة للنّقد السيميائي.. ولا نستطيع التغافل عن تجربة نقدية مثل قادة عقاق ومحمد عقاق، ولا يجب أن ننسى في هذا الإطار محلّلا نقديا مثل عبدالله بن حلي وبلقاسم بن عبدالله رحمه الله.. كلّ هؤلاء وغيرهم يمثلون الفيلق النّقدي الذي تمتلكه الجزائر، ومن شأنه أن يقدّم خدمات ناضجة لمصلحة النّقد الأدبي في الجزائر.”
النّاقد والأكاديمي محمد الأمين بحري: النّقد المحترف.. الـغائب الكبير..
يرى النّاقد محمد الأمين بحري أنّ “الجامعة الجزائرية تعرف إشباعا في أقسام الفنون والآداب وفي عدد الكتب والرسائل والمقالات المرتبطة بالنّقد، غير أنّنا نعيش نقصا فادحا في النّقد المحترف المقترن بخدمة الإبداع والفنون، عدا بعض الأعمال النقدية الحرّة التي يكون لها الأثر العميق على المنجزات الأدبية والفنية، لكنّها تبقى معزولة عن دوائر الإنتاج الفنّي والساحة الإبداعية”.
ونوّه محمد الأمين بحري –في تصريح لـ«الشعب” بالأجيال الحديثة، وتلك الأسماء المتوالية في مجال النّقد والأدب في الجزائر، على غرار السعيد بوطاجين ومخلوف عامر، ومن سبقهم من أسماء لامعة، قدّمت للنّقد الكثير مثل جيل بختي بن عودة ومحمد ناصر وعبد المالك مرتاض، ليأتي تلامذتهم أمثال عبد الحفيظ جلولي ومحمد خطاب وفيصل الأحمر.. وغيرهم ممّن ساهموا ـ في إعطاء نسق جديد للحركة النّقدية.
وأشار بحري إلى أنّ عملية النقد بالجزائر غير متوازنة الفئات، كون أنّ النّاقد الفنّي سيجد فيضا للممارسة ومتسعا للشراكة في المجالات الأدبية، على عكس الفنون الأخرى كالمسرح والسينما والموسيقى، وغيرها من الفنون، ليقول “هي المجالات التي يعدّ نقّادها على أصابع اليد أحياناً، ما يجعلنا نقول بأنّ كفّة النّقد الفني غير متوازنة فئويا وممارساتياً، وبالتالي تشهد بعض جوانبها تكتّلا فائضاً، بينما تشهد مجالات فنية أخرى ندرة وغربة رهيبة في النّقد الفنّي”.
ويعتبر بحري أنّ مسألة المؤهّل لممارسة النّقد بشكل عام، هي في الحقيقة حقّا مشروعا لكلّ من أوتي تمكينا فنيا أو تقنيا حول أيّ فنٍّ من الفنون التي تبرز لدى المنتقد، من خلال إبداء رأيه الانطباعي أو الدراسة الغنية بحسب درجة تمكّنه ومجاله في الممارسة النّقدية.
الأديب علاوة كوسة: “المنتج الشعري” لا يغري النقاد!
 أكّد الأديب علاوة كوسة، أنّ الحركية النّقدية في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، قلّ اهتمامها بالمنتج الشعري، وبات المشهد الثقافي حاليا يعيش ندرة في ما أسماه بـ«النّقد الشعري الجزائري”، مقارنة بالعقود الماضية التي عرفت فيها القصائد الشعرية دلالا ونشاطا لافتا من قبل رواد الحوارات الشعرية وأصحاب المبادرات الجادّة، الذين قدّموا أطروحات أكاديمية جادّة، باقتدار وإبداع..
أكّد الأديب علاوة كوسة، أنّ الحركية النّقدية في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، قلّ اهتمامها بالمنتج الشعري، وبات المشهد الثقافي حاليا يعيش ندرة في ما أسماه بـ«النّقد الشعري الجزائري”، مقارنة بالعقود الماضية التي عرفت فيها القصائد الشعرية دلالا ونشاطا لافتا من قبل رواد الحوارات الشعرية وأصحاب المبادرات الجادّة، الذين قدّموا أطروحات أكاديمية جادّة، باقتدار وإبداع..
أوضح علاوة كوسة في تصريح لـ«الشعب” أنّ النّقد ظلّ رفيقا للشعر منذ البدايات الخليلية الأولى، قراءة وانطباعا وآراءً نقدية مختلفة؛ وقال: “من ذا يحرم عاشقَ الشعر وسامعه من تذوّقه وإبداء ردّة فعله التذوّقية إعجابا أو استنكارا؟ وقد كان الشعر موطن الروح العربي الأول وسيبقى، ولا يختلف شأن الشعرية الجزائرية الحديثة والمعاصرة عن القاعدة الشعرية – النقدية العربية الحديثة، غير أنّ لكلّ زمان استثناءاته الشعرية وفلتاته النقدية التي يحفظها التاريخ الأدبي والنّقدي ويهمل غثّها”.
وأضاف كوسة: لو تصفّحنا على عجل، بعض تاريخ الحركة الشعرية الجزائرية لوجدنا القصيدة الجزائرية مدللة النّقد الجزائري إلى وقت قريب، تناولا ومقاربة ونقدا.. توزّع حبره على الكتب والأطاريح والصحف”، ثم تساءل: “من غيّر أحوال العلاقة الحميمية بين الشعر الجزائري ونقّاده؟ إذ هجروه بلا سبب نقدي مقنع”.
ويذكر كوسة بأنّ القصيدة الجزائرية “كانت محظوظة بقربها من العرش النّقدي المهيب، ومكّن لها بعض النقّاد ولو بأضعف المقاربات والمناهج الحافية الوافدة علينا من غير وعينا بها وبمحاضنها الغربية وبالمخيمات الشعرية المحلية، المهيّأة لها كمناهج لاجئة لمواطن مازال فيها النّقد فتيا، فهجرنا كثيرا من شعرنا الجزائري إلى مقاربات وإجراءات ظننّاها ستستعمر النصوصَ، دلالات ورؤى فاستفرغتها من طينتها الشعرية الأولى”، ليضيف: “ولكنّ ذلك لا ينفي محاولات ومناورات نقدية جزائرية جادّة احتفت لعقود بالتجربة الشعرية الجزائرية، وحاولت تسويقها نقديا إلى القارئ الجزائري والعربي، وبعض النوايا النّقدية أفضل من الصمت النّقدي، وإن كان خراجها قليلا”.
ويطرح علاوة كوسة تساؤلات حول راهن النّقد الشعري في الجزائر، بقوله: “هل يمكن القول إنّ هذا الجيل النّقدي قد اتخذ الشعر الجزائري مهجورا، أم إنّ معظم النقّاد الجزائريين قد هاجروا إلى نقد الرواية والنثر عموما، استسهالا ومواكبة للموضة النّقدية الجزائرية والعربية؟ وهل يحقّ لي أن أقول: إنّ هجرة النقّاد الجزائريين للقصيدة الجزائرية كان تخوّفا منهم لأنّ كثيرا من النقّاد الأكاديميين (ككثير من طلابنا) لا يمتلكون معظم مفاتيح قراءة النصّ الشعري؟ واسألوا المنتج النّقدي الجزائري المعاصر كتبا وأطاريح ومداخلات وملتقيات فالحقيقة هناك”.
الأستاذة وردة لواتي: النّاقد مطالب بمواكبة الحركة النّقدية العالمية
ترى الأستاذة الجامعية وردة لواتي، أنّ المتتبع للحركة الأدبية والنّقدية في الجزائر يلتمس بوضوح وجود معالمه الواضحة التي لا غبار عليها، ولا يمكن لجاحد أن ينكرها على الرغم من وجود بعض التحفّظات للمقبلين على الممارسة النّقدية الذين يفتقدون – في معظمهم – للتخصّص في المجال، وهذا ما يفرز بعض الفهم الخاطئ لبعض النصوص، وخاصّة مع الفهم غير الصحيح لوظيفة النّقد، وافتقار الممارسين للعملية النّقدية للمنهج المناسب.
دعت أستاذة الأدب العربي بجامعة الحاج موسى أخاموك بتمنغست، الدكتورة وردة لواتي في حديث لـ«الشعب”، النّاقد الجزائري إلى مواكبة الحركة النّقدية العالمية، في إطار ما يعرف بـ«نقد النّقد” الأمر الذي يحدث في رأيها نوعا من التفاعل الفكري الواعي، انطلاقا من مرجعيّته الفكرية والثقافية وخصوصيته الاصطلاحية.
يحدث هذا – تقول المتحدّثة – بعد مرور النّقد بعدّة مراحل منذ ظهوره، حيث يجمع الباحثون في مجال الأدب والنّقد أنّ هذا الأخير كانت انطلاقته في الجزائر محتشمة، كما تؤكّد الدراسات والبحوث على أنّ الخطاب النّقدي في الجزائر لم يرق للمستوى الذي يؤهّلنا لاعتباره خطابا نقديا قائما بذاته، فهو لا ينفكّ أن يكون عبارة عن محاولات بسيطة حوتها بعد الصحف والمجلات، فالحركة النّقدية الأدبية في فترة ما قبل الاستقلال – تقول لواتي – كانت بمثابة الإرهاص، وانعكست الظروف السياسية والاجتماعية على الساحة الأدبية والنّقدية بما لم يدع المجال لأيّ انفتاح على الآخر، أين ركّزت هذه الفترة على إحياء التراث والعودة إلى كلّ ما هو أصيل كردّ فعل على ما تفرضه الفترة الاستعمارية، فجاء النّقد الأدبي في الجزائر متأخّرا نسبيا واستمر الوضع على ما هو عليه لفترة من الزمن في ظلّ ظروف سادتها البساطة في الإبداع الأدبي.
هذه المرحلة رغم ضعفها – تضيف محدّثتنا – كانت بمثابة القاعدة التي أسّست لظهور نمط آخر من الأعمال الإبداعية والنّقدية تزامنت وحصول الجزائر على حريتها وسيادتها، حيث ظهرت أعمال أكاديمية تؤسّس للنّقد وتدعمه، وكانت انطلاقته مع أبي القاسم سعد الله، مخلوف عامر، عمار بن زايد، عبد الله الركيبي.. وغيرهم ممّن قدّموا إسهاماتهم الأكاديمية التي عالجت إشكالية النّقد، المنهجية الاصطلاحية، والعديد من الدراسات التي وضعت النّقد الجزائري على السكّة الصحيحة، وبدأت خطوة الألف ميل محاكية الحركة النّقدية المشرقية ونهضتها التجديدية.
تقول لواتي: “مع تطوّر الصحافة واتساع المقروئية وبصدور بعضها باللغة العربية، فتح المجال لتطوّر الحركة الإبداعية والنّقدية، وأسهمت بشكل مباشر في تطوّر النّقد الأدبي الذي عرف حركية واسعة على الصعيد العربي والعالمي، حيث ظهرت اتجاهات جديدة تنبنّي على مفاهيم نقدية حديثة، فكانت الانطلاقة الحقيقية للنّقد في الجزائر على يد ثلّة من الرواد أدركوا القيمة الحقيقية لدور النّقد في دفع حركة الإبداع الأدبي، وهذا لا يجعلنا ننكر جهود الرواد الأوائل الذين صبغوا النّقد بصبغة الأصالة.
وترى محدّثتنا بأنّ فترة الثمانينات من القرن المنصرم تعدّ المرحلة الفيصل في التأسيس الحقيقي للنّقد الجزائري، من خلال تجربة عبد الله الركيبي بكتابه “الشعر الجزائري الحديث”، وتجربة “الكتابة الواقعية لدى الطاهر وطار” لواسيني الأعرج.. والتجربة النّقدية للنّاقد محمد ساري (البحث على النّقد الأدبي الجديد)، وغيرهم كثير، حيث توالت الأعمال النّقدية تباعا مع ثلّة من النقّاد الجزائريين، وهنا يكون النّاقد الجزائري – تؤكّد لواتي – قد قطع شوطا كبيرا في الممارسة النّقدية التي وظّف فيها جملة من المناهج النّقدية الحديثة، دون إهمال الجانب المفاهيمي الذي ألقى عليه الضوء في محاولة منه للتعريف بها، وإزاحة اللّبس للباحث والدارس معاً..