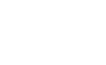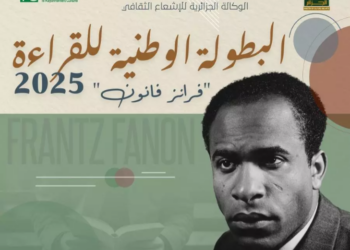في زَمَن الـ GPT، أَمازالَت الكلمة الطَّيِّبة صَدَقَة؟ أَم غَدَت فَاتُورَةً تُسَدَّدُ بِالدُّولار والواط؟”.
صَارَ الذَّكاءُ الاصطناعيّ اليَومَ يَعدُو عَدوَ السَّيلِ إذَا انحَدر، وتَهتدي خَوارِزمِيّاتُه إلى مَسالِكَ لا عَهدَ للبَشَر بها، حَتَّى طالَعَتنا مُفارَقاتٌ لَم تَكُن على البال، ولا خَطرَت في سُجْحِ المَقال. وَمِن غَريبِها المَنقُولُ عن “سام ألتمان” – الرَّئيس التنفيذي لِشَرِكَة OpenAI – إذ قال قَبلَ أيَّامٍ: “التَّعامُلُ المُهَذَّب مع ChatGPT يُكَلِّفُنا مَلايين الدُّولارات”..!!!

وهذا الكلام – وإن بَدا للسَّامِع ساذَجًا – فهو عِند الفَحص ضَربٌ من القنابل المَعرِفِيَّة التي تَهدِمُ حُدودًا كانت تُحسَبُ مَنيعةً بين الخِطاب البشري والمُحاكاة الآليّة، وتُثيرُ أسئلةً عِظامًا عن مَعنَى التواصل، وحُدود الأخلاق، وسِعرِ التَّأَدُّبِ الرَّقميّ في عَصرٍ تُستَهلَكُ فيه الكلمات كما تُستَهلَكُ الطاقة.
وفي صَمِيمِ تَصريحِ “ألتمان” يُقِيمُ مَفهومٌ تقنيّ يُعرَف بالـ Human-like Prompting، وهو ما يُقابِل في العربية “التوجيه الإنساني في صَوغ الأوامر”؛ فالمُستَخدِم لم يَعُد يَقولُ للآلة: “اكتُب مَقالًا”، بَل يُتبِع أمرَه بِما يَدُلُّ على التهذيب والتأنُّق، مِن قَبيل: “من فضلك”، “لو تكرَّمت”، وغيرها.. وهذه العِبارات – وإن كانت مِمَّا يُستَحسَنُ في المَجالس – فهي لا تُضِيفُ للطَّلَب جَوهَرًا، غَير أنّها تُثقِلُ كاهل الخَوارِزمِيَّات بكثرة الرموز النَّصِّيَّة (Tokens)، وهي وحدة القياس في منظومات الـ GPT. وعِندَ تَراكُم هذه الرُّموز، يَتَحَقَّقُ ما يُعرَف بالـ Token Inflation، أي “تَضَخُّم الرموز”، فيَغدو كلُّ طلَبٍ لَطِيفٍ حَمَّالَ كُلفَةٍ زائدة، ومُعالَجةٍ أطوَل، وفاتورةٍ أكبَر؛ فالمُجامَلة هُنا لَيسَت خُلُقًا يُحمَد، بَل حِسابًا يُسَجَّل بِالدُّولار والواط!
يَكشِفُ تَصرِيح “ألتمان” أيضًا عن صِراعٍ خَفِيٍّ بَينَ المُجامَلة وحُسن الأداء؛ إذ تَغدو الأخلاقُ عِبئًا، والمُجامَلةُ خَطرًا بِيئِيًّا واقتِصاديًّا،في بِيئةٍ سَحابِيَّة (Cloud-based Infrastructure)، يُقاسُ فيها كلُّ استِعلامٍ بِما يَستَهلِكُه من طاقةٍ وزَمنٍ ومُعِدَّات حَوسَبةٍ مُكلِفَة، مِثل وَحَدات مُعالَجة الرُّسومِيَّات (GPU).
فَهَل نُبقي للنَّاس حَقَّ الحَديث إلى الآلة كما يُخاطِبون ذَوي الأرحام؟ أم نُرَشِّدُ السُّلوكَ إلى الـ Prompt Optimization، أي “الإيجاز المُثمِر والتَّفاعُل الدَّقيق”؟
والذي يَحمِلُ النَّاسَ على مُخاطَبَةِ الآلة مُخاطَبَةَ الإنسان، إنما هو مَيلٌ فِطريّ إلى الـ Anthropomorphism، أي “إضفاء الصِّفات البَشَرِيَّة على ما لا رُوح له”. لَكِنَّ الخَطَرَ الأعظم أن تَـقَـعَ في الـ Emotional Reification، أي في “التَّشَيُّئ العاطِفِيّ”، فَتَصيرَ الآلةُ مَوضوعَ عاطفةٍ وَوِجدان، وهي لا تَحُسُّ ولا تَشعُر، ولا تَدري أأُكرِمَت أم أُهِينَت!
ثُـمَّ إنَّ في تَعامُلنا مع الآلة مُفارَقةً نَفسِيَّةً صارخة تُسمَّى الـ Cognitive Dissonance، وتَعنِي “أنْ نُدرِك أنَّ الآلة لا تَعِي، ولا تُبصِر، ولا تُحِسّ، ثمّ نُكَلِّمَها كَلامَ المَوَدَّة والاحتِرام، كأنّ بَينَنا وبَينَها رَحِمًا وسَبَبًا”..! وتِلك ازدِواجِيَّةٌ تُنتِجُ سُلوكًا زائِفًا يُسَمَّى الـ Pseudo-affective Behavior، أي “تَوَدُّدًا مُصطَنَعًا إلى كائنٍ لا يَفهَم، ولا يُبالي”.
وما نَعيشُه اليَومَ لا يَخلُو مِن بُعدٍ فَلسَفيٍّ وُجُوديٍّ، يُعرَف بالـ Ontological Paradox، وهو “أن نُخاطِب كائنًا لا وُجودَ له على نَحوٍ يُشبِهُنا، ولا حَياةَ فيه، كأنّه مِنّا وفِينا”. بَل إنَّ الأمرَ يَتَجاوَزُهُ إلى الـExistential Delegation، أي “تَفويضٍ وُجُوديٍّ للآلة”، حَيثُ نَجعَلُها تَسأل وتُجيب، وتَشرَح وتُعَلِّق، حتى لا يَبقَى للإنسان ما يُعرِّفُ به ذاتَه، إذا كانت الآلة تُجيدُ مُحاكاةَ ذلك كُلِّه.
وَأشَدُّ ما في تصريح “ألتمان” أنَّـهُ يُـنَـبِّـهُ إلى خَطَرٍ داهِمٍ على استِدامَة هذه الأنظمة. فإذَا كانت كلماتٌ من باب التَّأَدُّب تَجُرُّ مَلايين الدُّولارات، فَكَيف بِما هو أشَدُّ من ذلك من الاستِخدام المُفرِط العاطفيّ؟
وفي ما قَلَّ وَدَلَّ أقُولُ إنَّ تَصريحَ “ألتمان” لَيسَ مِن فُضولِ الكلام، بل هو ناقوسٌ يُدَقُّ في آذان الحَضارة. فإمّا أن نَستَرسِلَ في “أنسَنةِ الآلة” فنُفلِسَ ونُدَمِّرَ البِيئة، أو نُراجِعَ لُغَتَنا، ونُصلِحَ سُلوكَنا، ونَكُفَّ عن التَّوَدُّدِ لِمن لا يَفهَم ولا يُبالي؛ فالآلةُ لا تَدمعُ إن أهَنتَها، لكنَّها تُحَمِّلُ الأرضَ كُلَّها ثَمَنَ كَلِمَتِك الطَّيِّبة مَعَها.
عمار قواسمية
مترجم-مدقق لغوي-ناشط ثقافي